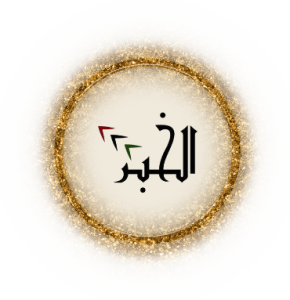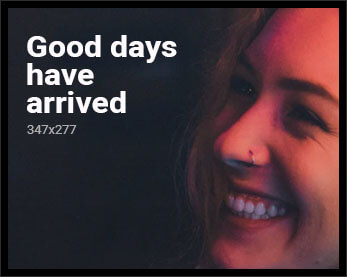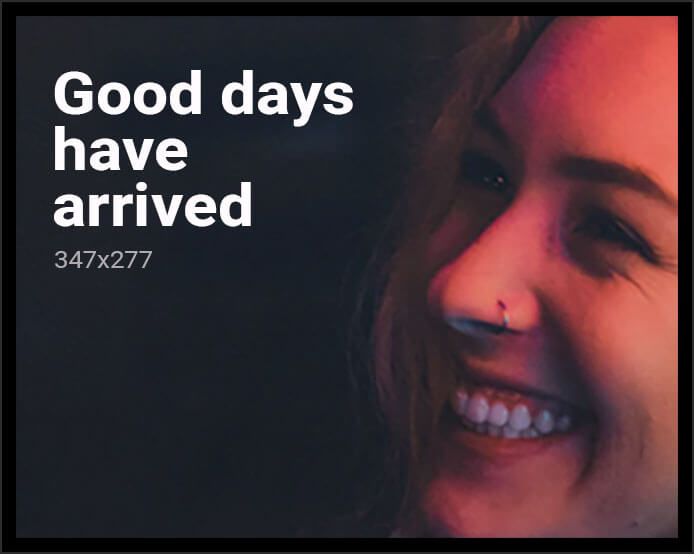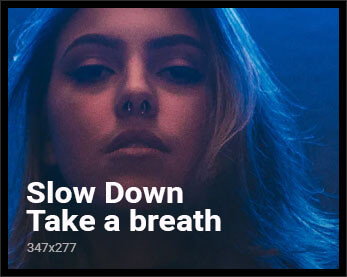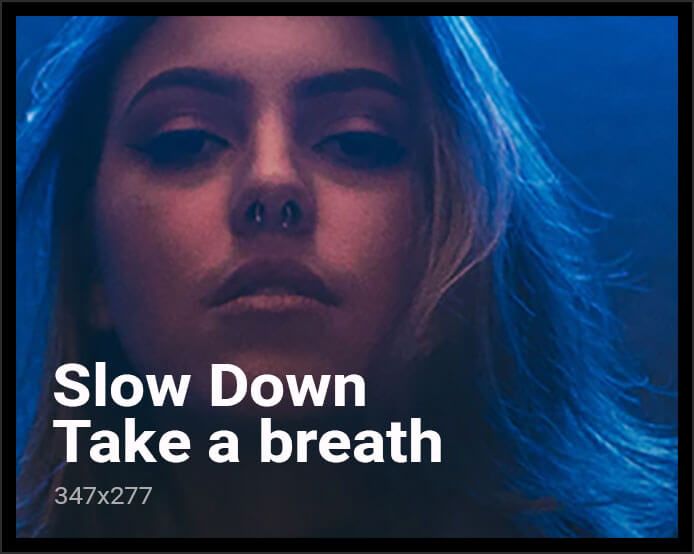مع انطلاق الاستحقاق البلدي والاختياري في لبنان، يعود النقاش إلى الواجهة حول دور البلديات، هوية المرشحين، وشكل التحالفات. إلا أن هذا النقاش، في جوهره، يعيد إنتاج مأزق لبناني مركّب، حيث يتحوّل التنافس البلدي من فرصة للمساءلة والتنمية إلى صراع على النفوذ والتمثيل، في إطار نظام امتيازات يختزل السياسة بالولاء والمواطنة بالتبعية.
ليست أزمة الانتخابات البلدية أزمة عابرة، بل هي أزمة تمثيل محلي بنيوية تتجذّر في نظام سياسي اجتماعي يحوّل الطائفة والعائلة من وسائط مشاركة ديمقراطية إلى أدوات نفوذ.
نظرياً، تُعتبر الانتخابات البلدية الأداة الأقرب للمواطن، والحيّز الأول لتطبيق الحكم الرشيد والحوكمة المحلية. لكن في الممارسة اللبنانية، تنعكس هذه الانتخابات مرآةً دقيقة لبنية السلطة القائمة، حيث يُنتج “التمثيل المحلي” عبر شبكات الولاء العائلي والطائفي والمناطقي، لا عبر التنافس بين مشاريع تنموية أو رؤى إدارية.
في القرى ذات الطائفة الواحدة، تُشكَّل المجالس البلدية على أساس الولاءات العائلية والفئوية، ويُقدَّم المرشح كـ”ابن البيت” لا كصاحب برنامج. أما في القرى المختلطة طائفياً، فيتحوّل الاقتراع إلى اختبار توازن طائفي هشّ، تغيب فيه الكفاءة ويغيب معه النقاش حول الأولويات الإنمائية. وفي المدن الكبرى، تُدار الانتخابات كتحالفات بين زعامات سياسية ومصالح اقتصادية، فيتحوّل العمل البلدي إلى ملحق سياسي لا إلى سلطة محلية مستقلة.
هذه الأزمة ليست طارئة، بل نتيجة مباشرة لنظام زبائني يُعيد إنتاج نفسه مع كل استحقاق انتخابي، ويُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها التنموي. فالطائفية، رغم خطورتها، ليست جوهر المشكلة، بل أداة في نظام الامتيازات اللبناني، حيث تُفضَّل الجدارة بالانتماء، والكفاءة بالولاء، والخدمة المشروطة على الحق المكتسب.
هذا النظام، المُصنّف في علم الاجتماع السياسي ضمن نماذج “الرعاية الزبائنية” (Clientelism)، لا يسمح للبلديات بأن تكون منصات للتخطيط المحلي والتنمية المجتمعية، بل يحوّلها إلى مراكز نفوذ لتوزيع الخدمات على قاعدة التبعية والوساطة. والنتيجة: ضعف في مساءلة المنتخبين، غياب للبرامج التنموية، وتحول التمثيل المحلي إلى وظيفة رمزية لا أدائية.
فكيف يكون الإصلاح؟
لا يكفي التنديد بسلوك الناخب أو المرشح، بل يجب النظر إلى المسألة من منظور بنيوي يقتضي تدخلًا متعدد المستويات:
- إعادة بناء الإدراك السياسي المحلي: ما يعرف في علم النفس الاجتماعي بـ”إعادة تأطير الإدراك الجمعي”، أي نقل التفكير من الهوية إلى الأداء: لا نسأل “ابن مَن هو؟” بل “ماذا يقدّم؟”
- إصلاح القانون الانتخابي البلدي: النظام الأكثري يعزز العصبيات، والمطلوب اعتماد النظام النسبي على أساس البرامج، مع تشجيع المجتمع المدني والمجموعات المستقلة على خوض الانتخابات.
- تمكين الشباب: الشباب هم الفئة الأبعد عن النظام التقليدي، والأكثر قدرة على كسر الحلقة المفرغة، شرط حصولهم على التدريب، والدعم القانوني، والتمثيل الإلزامي (الكوتا).
- تطوير الإعلام المحلي: من الضروري الانتقال من تغطية الزعامات إلى متابعة المشاريع والموازنات، ومن الخطاب التمجيدي إلى آليات الضغط والمحاسبة.
- فصل الخدمات عن التمثيل السياسي: لا ديمقراطية محلية ممكنة دون مؤسسات خدمية مستقلة وشفافة يحصل المواطن عبرها على حقوقه من الدولة، لا من الزعيم أو الوسيط السياسي.
البلدية ليست كياناً تقنياً صغيراً، بل مختبراً مصغّراً للديمقراطية الممكنة. إصلاحها لا يعني فقط تحسين الطرق والنفايات، بل اختبار قدرة اللبنانيين على كسر نظام الامتيازات، وبناء نظام محلي عادل، تمثيلي وفعّال.
فأزمة التمثيل المحلي هي انعكاس لثقافة سياسية اجتماعية عميقة. وإذا أردنا مستقبلاً مختلفاً، فإنّ نقطة الانطلاق تبدأ من إعادة تعريف التمثيل على مستوى الحي، الحارة والقرية، بالتوازي مع مشروع وطني تغييري أوسع.