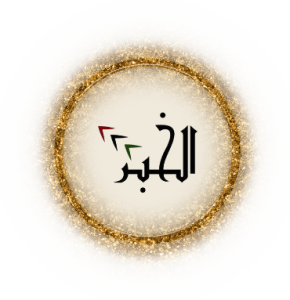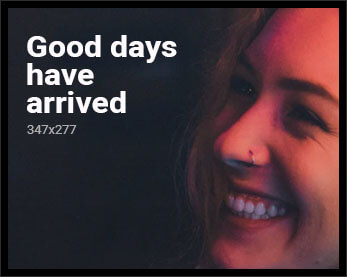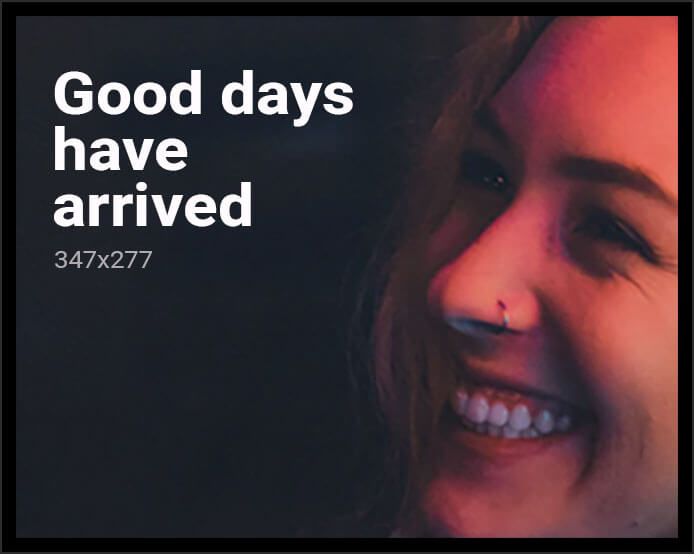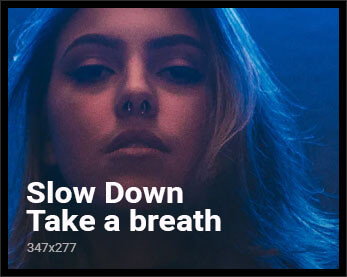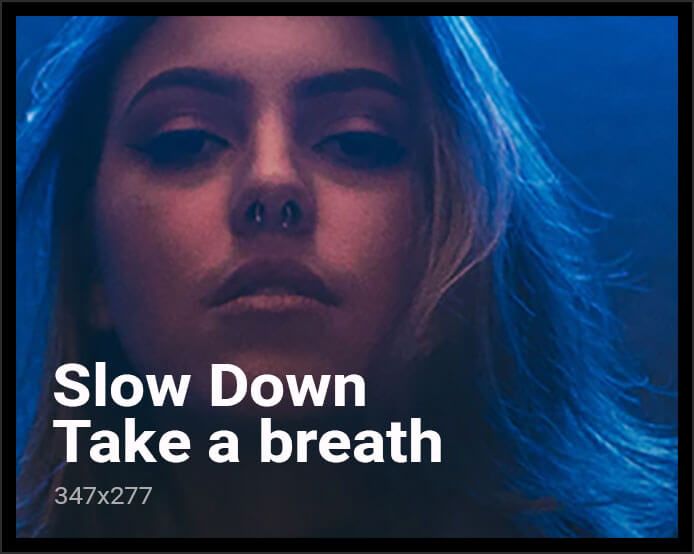دراسة من “غوغل” تحلل تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي لإحياء الموتى رقمياً، من نصح الأحفاد إلى كشف أسرار الماضي.
كان من المعتاد أن يموت الإنسان، وتُدفن معه قصصه وصوته وحتى ملامح شخصيته. لكن ماذا لو لم يعد الموت نهاية الحكاية؟ ماذا لو عاد الجد ليخبر حفيدته كيف تُصلَح صنبور الماء، أو ليقدّم نصيحة في الحب أو الحياة؟
هذا ليس مشهدًا من فيلم خيال علمي، بل سيناريو واقعي يتشكّل تدريجيًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
“الأشباح التوليدية”: من الخيال إلى الواقع
ما يُعرف اليوم بـ”الأشباح التوليدية” لم يعد فكرة نظرية أو لعبة تقنية. إنها نسخ رقمية من الراحلين، صُمّمت لتحاكي أصواتهم، سلوكهم، وحتى طريقة تفكيرهم.
في بعض الحالات، تتطوّر هذه الأشباح لتتحول إلى مساعدين رقميين: يتحدثون، يعلّمون، يقدّمون النصائح، بل وحتى يكسبون المال لعائلاتهم بعد وفاتهم.
هذه التقنية تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات شخصية يجمعها الأفراد قبل الوفاة: تسجيلات صوتية، فيديوهات، مقابلات طويلة، صور، وذكريات مكتوبة. بعد الرحيل، تُستخدم هذه البيانات لإنشاء كيان رقمي يمكن التفاعل معه — نسخة رقمية تشبه الأصل بدقة مذهلة.
منصة لتخليد الذكريات… أم حياة رقمية بعد الموت؟
شركات ناشئة عديدة دخلت هذا المجال.
منها مثلًا شركة “Re;memory” التي تُجري مقابلات معمّقة لتكوين أرشيف تفاعلي رقمي للراحلين، وتطبيق “HereAfter AI” الذي يبني شخصية رقمية قائمة على المحادثة.
النتيجة: روبوت محادثة تفاعلي تستطيع العائلة التواصل معه، لا لاسترجاع الذكريات فحسب، بل للحديث عن مناسبات عائلية حالية أو حتى تلقي نصائح منزلية ويومية.
تقبل ثقافي متفاوت… ومهام غير متوقعة
بعض الثقافات، خاصة في شرق آسيا، تقبّلت هذه الفكرة بسهولة نسبيًا، خصوصًا في المجتمعات التي تحتفظ بعلاقات رمزية مع الأجداد. أما في السياق الغربي، فيختلف التفاعل حسب الخلفيات الثقافية، الدينية، والمواقف الفردية من التكنولوجيا والموت.
لكن الأشباح الرقمية لا تقتصر على الجانب العاطفي أو التذكاري.
فبعضها بات يُكلَّف بمهام عملية: شرح إجراءات بيروقراطية، مشاركة وصفات عائلية، أو حتى تقديم نصائح مهنية، خصوصًا إذا استندت إلى شخصية خبير أو مؤثر راحل.
بل من غير المستبعد أن نرى “أشباحًا عاملة” تُنتج محتوى، تدرّس، أو تكتب باسم من رحلوا، ضمن اتفاقات تجارية جديدة من نوعها.
مخاطر نفسية وأخلاقية… وأسرار مهددة بالانكشاف
رغم الجاذبية التكنولوجية، لا تخلو هذه الظاهرة من مخاطر.
أبرزها التعلّق العاطفي الزائد بكائن رقمي لا يمكنه أن يعوّض الفقد الحقيقي. كما أن هذه النماذج قد تُنتج معلومات خاطئة — بسبب ما يُعرف بـ”هلوسات الذكاء الاصطناعي” — أو تعبر عن أفكار لم تكن يومًا من صلب شخصية المتوفى.
الأخطر أن تُستخدم هذه “الأشباح” في مضايقات بعد الوفاة، نشر رسائل عدائية، أو تنفيذ أنشطة مشبوهة باسم شخص لم يعد موجودًا للدفاع عن نفسه.
هل من قوانين تضبط “العودة”؟
كل ما سبق يطرح أسئلة قانونية وأخلاقية ملحّة:
من يملك الحق في استخدام صوت أو صورة المتوفى؟ من يراقب ما تقوله النسخة الرقمية؟ ومن يتحمّل المسؤولية إن أساءت هذه النسخة أو خالفت إرادته الأصلية؟
حتى الآن، لا توجد منظومة قانونية متكاملة تحكم هذه الظاهرة، ما يجعل الحاجة مُلحّة لتشريعات تواكب هذه القفزة في التعامل مع الذكرى والموت.
موت مختلف لعصر مختلف
يبدو أننا أمام مرحلة جديدة يُعاد فيها تعريف “النهاية”.
في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد الموت قاطعًا كما عرفناه. بل قد يصبح الموتى، بطريقة ما، أكثر حضورًا من الأحياء — يتحدثون، ينصحون، يشاركون، وربما… يعملون من العالم الآخر.